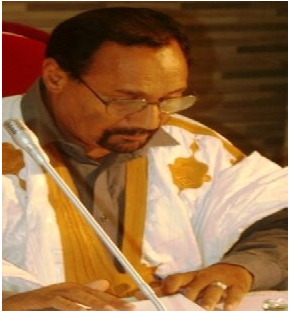
لعل التوازن الذي تعيشه الدول المتقدمة في مساراتها التنموية و استقرارها و رفاه أهلها هو ناتج عن قدرتها على جعل السياسة موجهة توجيها مباشرا لخدمة القضايا التي تهم شعوبها وأوطانها وتضمن لها النماء والرقي. فلماذا ضاعت الرؤيا إذا عن سياسيي البلد ؟
أكد البنك الدولي في أحد تقارير عدد شهر أكتوبر 2014 من "نبض أفريقيا" الذي يصدر مرتين سنوياً و يحلل القضايا التي تشكل الآفاق الاقتصادية في أفريقيا، أنه رغم ضعف النمو العالمي عن المتوقع واستقرار أسعار السلع الأولية أو انخفاضها، فإن اقتصاد البلدان الأفريقية مازال ينمو بوتيرة سريعة بعض الشيء، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بالمنطقة إلى 5.2 في المائة سنوياً في عامي 2015-2016 من 4.6 في المائة عام 2014 بحسب التقرير.
ترى أين تكون المكانة التي تحتلتها موريتانيا من هذا التوقع الاستقصائي خلال العام 2015 الذي يوشك أن ينقضي؟
و ما هي التوقعات للعام المقبل 2016، و بأية مقاييس اقتصادية أو قواعد تصنيعية قائمة يمكن قياسها و اعتمادها، علما بأن عائدات المناجم من حديد و نحاس و ذهب و غيرها و من البترول لا تأتي إلا مَالاً أي "سيولة" نقدية يفترض أن ما يفيض منها عن تسيير شأن العمال في كل مفاصل مؤسسات هذه الجهات الاستخراجية و صيانة التجهيزات و الآلات الثقيلة، يعود إلى الحزينة العامة للدولة التي توجهه إلى العملية التنموية متمثلة في قيام البنى التحتية و إعداد و تسيير المرافق العامة على امتداد التراب الوطني ؟
و ما هو دور السياسية و السياسيين في سياق هذه الدينامية الاقتصادية التي تحدد قدرة البلد من خلال إمكاناته و قدرة مُسيريه و قادته على حفاظ بقائه و من ثم تطوره و استقراره؟ و هل الدور إلا خطابا أحادي الجانب، مركز التوجه إلى حيث استلام السلطة و التربع على عرشها مُنتزعة من قبل إفرازات لا تنتمي بتركيبتها الفكرية القائمة و أسلوبيتها الخطابية و جمودها الحركي إلى الفكر الوطني المترفع عن دونيات تأويل القضايا الجوهرية أكثر من انتمائها لاعتبارات اجتماعية، ما زالت متعلقة بتلابيب الماضي الإقطاعي، التراتبي، الانتقائي، التي تنتزع المكانة بغير قوة "الكارزما" الإيجابية في رحاب التنوير العقلاني.
و ليست "العبرة" في إدمان شروح أوجه السياسة و مجالات تطبيقها بقدر ما إنها تكمن حقيقة في مدى أو عدم قدرة تلبية الغايات الوطنية الكبرى المرجوة من وراء أدائها على أيدي من يفترض أن يكونوا صفوة منتقاة و "ما ينفع الناس" في مكث المبادئ و القيم السامية.
و من المعلوم أنه يتم على العادة الحكم على نجاح حكومة أو حزب سياسي أو جماعة وصلت إلى السلطة ـ أيا كانت الطريقة التي وصلت من خلالها ـ عن طريق المراقبة و المتابعة للأداء السياسي في المواقف والأحداث التي تواجهها. و من هنا فإذا ما أردنا الحديث عن الأداء السياسي لعموم أحزابنا و إن تتراوح ما بين العبثي و المائع و التنظيري الخالص و المسجل بعض إرهاصات خجولة تصب في ميزات حسنات وجودها، فإننا بصدد الحديث عن نوع من الأداء السياسي الهزيل بكفة التقييم و التقويم في التعامل مع المواقف والأحداث السياسية التي تعيشها البلاد و من خلال ما تقوم به كُلها من فرض لسياسة الأمرٍ الواقع و من تغييب لأية قدرة على القراءة السياسية الواضحة المعالم و السليمة المرامي.
ففي الوقت الذي تضع فيه حكومات دول كثيرة حول العالم قواعد "مدينة المستقبل" و تسعى فيه الشعوب إلى تجسيد ذلك على أرض الواقع، يظل المواطنون في عاصمة هذا البلد بعيدين كل البعد عن أي عمل ميداني تلقائي أو مؤطر سياسيا يسعى إلى إزالة مستنقعات المياه الآسنة من جراء التساقطات المطرية أو سوء حال شبكة المياه المتهالكة التي تزكم الأنوف و تخنق الأرواح في بعض أكثر أحيائها عراقة و حيوية و نشطا منذ تأسيسها في نهاية خمسينات القرن العشرين. صحيح أن السلطات العمومية و البلدية تدخلت في أكثر من محور و لكنه تَدخلٌ كشف عن ضعف استعداد و غياب وسائل و معدات مناسبة و أسلوب مطلوب، كما هو صحيح أيضا أن العديد من الأحزاب السياسية أصدر من البيانات التي تشجب قيام هذا الوضع في عاصمة البلد التي هي المرآة العاكسة إلى لعالم وجه البلد الحقيقي، و لكنها غابت بأحجامها عن العمل الميداني من خلال استنهاض الهمم و رص الجهود و انتهاج خدمة الوطن هدفا و مبتغى دون انتظار و بتأجيل كل المقاصد سواه.
وفيما تغيب إلى حد اللحظة في هذا البلد كل ملامح التصنيع و في أبسط أوجهه تنفتح جيبوتي الدولة العربية الواقعة في طرف القرن الإفريقية، محاذية لباب المندب عند نقطة التقاء البحر الأحمر و المحيط الهندي، القليلة عدد السكان و العديمة المساحة، على جيرانها بفائض منتجاتها المحلية، و قد استطاعت أن تؤسس لصناعة محلية بدأت تدخل إليها "الممكننة" تحول إلى مواد استهلاكية بعض منتجاتها الزراعية، و الرعوية و البحرية لتضع علامة "صنع في جيبوتي" لتصدر بعد تلبية الاستهلاك المحلي لهذه الدول المجاورة و ضمن تبادل تجاري أخذ ينشأ على أسس تبادل منتج الصناعة بينها. و تلك مالي تغرق أسواق البلد بعسلها الذي يحمل شارات مصانعها و بأشياء أخرى كمادة "الكاريته" المشتهرة للتداوي و غير ذلك، و تلك السنغال تضخ هي الأخرى بموادها البلاستيكية التي تأخذ كل الأشكال و الأنواع من الحصير إلى كوب الشرب و تحمل من تحتها و من فوقها و على جنباتها عبارة "صنع في السنغال"، ناهيكم عن الجزائر و المغرب اللتين دخلتا نادي التصنيع الثقيل. هي إرهاصات صناعية حقيقية بدأت في مجملها تخلق لهذه البلدان حيزا من السوق الإقليمية الكبرى بعدما استطاعت أن تمد سكانها بالمهارات التقنية و العلمية الضرورية و تحقق لهم اكتفاء محليا من حاجياتهم الأساسية و الاستفادة من تحويل بعض ثرواتهم و مقدراتهم الطبيعية التي كانت تذهب كلها إلى التصدير في صفقات خاسر و مخجلة. و لم يتأتى ذلك مطلقا لهذه البلدان و غيرها حول العالم إلا بعدما نضج الوعي السياسي فيها و تجاوز كل عوائق مرحلة التخلف الفكري و الاجتماعي و قيودهما السلبية.
و لا شك في المقابل أن أغلب قيادات الأحزاب في موريتانيا تفتقر ـ حتى و لو لم تعترف ـ إلى الحنكة والخبرة السياسيتين اللازمتين و هي تمعن بالانغماس تماديا في الخطاب السياسي العقيم، المتشنج و القائم على عقلية وثقافة الإقصاء الذي يعتقد المتعاطون ضمنها أنهم من خلاله يستطيعون تسيير الأمور وإدارة البلد، و لا يدركون أنها عقلية أو فكر قاصر في التعامل سياسياً مع الأحداث و دليل مؤكد على أن أداء هذه الأطر السياسية ـ التي لم تستوعب بعد واقعها المتخاذل عن رفع الوطن فوق الاعتبارات الضيقة ـ ضعيف وأنه بذلك إنما يلعب الدور الأكبر في توسيع الفجوة فيما بينها داخل ميدان العمل المشترك و لا تكترث و أنه بالنتيجة يقوض فكرة أو مسار أي حوار يراد له أن يقوم و يرفع البلد إلى مدار التنمية و البناء الاستقرار.

.gif)





